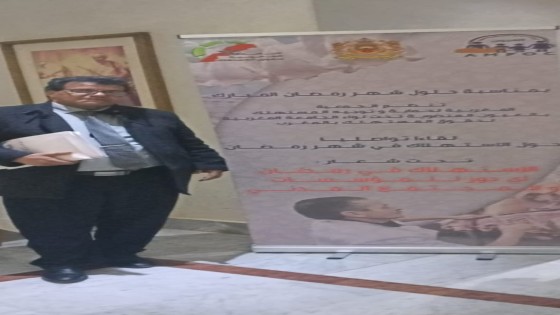من يُتابع التطورات الأخيرة في المشهد الحزبي المغربي، وتحديداً ما جرى في مدينة الداخلة خلال تجمع لحزب التجمع الوطني للأحرار، لا يحتاج إلى كثير من الجهد ليدرك أننا أمام لحظة فاصلة، لم يعُد فيها الفصل بين الحكومة والحزب مجرّد إشكال نظري، بل صار واقعاً محسوساً تُترجمه الأفعال والخطابات.
تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بأن النائب البرلماني امبارك حمية، وهو أيضاً أمين مجلس النواب وعضو بارز في حزبها، قد استفاد من دعم مالي بقيمة 11 مليون درهم لإقامة مشروع خاص في تربية الرخويات، لا يمكن قراءته من زاوية تقنية صرفة. بل هو إعلان صريح عن طبيعة النسق الذي بدأ يترسخ داخل الحزب القائد للتحالف الحكومي. نسق يقوم على تمركز أدوات الدعم العمومي داخل التنظيم الحزبي، وتوزيع الامتيازات بناء على منطق القرب السياسي، لا على معايير الاستحقاق أو مبدأ تكافؤ الفرص.
إن كاتبة الدولة لم تتحدث بصفتها مسؤولة في قطاع حكومي استراتيجي، بل بصفتها طرفا في ترتيب داخلي لمنظومة حزبية تستعمل لغة التنمية لتثبيت شبكة النفوذ داخل الجهات والأقاليم. هذا التداخل بين الخطاب الحكومي والوظيفة الحزبية هو بمثابة دليل على ما يمكن تسميته بـ”التحزيب البنيوي للسياسات العمومية”، حيث تتحول المشاريع الممولة –سواء من ميزانية الدولة أو من مؤسسات دولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية– إلى أدوات تأثيث لمشهد سياسي موجه سلفاً.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي حضر اللقاء ولم يعلق أو يعقّب، أعطى بصمته لهذا التصور، حيث أن الصمت هنا لا يمكن تأويله إلا باعتباره قبولا ضمنياً بأن تنخرط مكونات الحكومة في ترويج ثقافة الامتياز الحزبي، وتجيير المال العام في خدمة أجندات حزبية، تقوّض أسس العدالة الاقتصادية والإنصاف المجالي.
ومن الناحية السياسية، فإن هذا النموذج يفتح الباب أمام انهيار تدريجي للثقة بين المواطن ومؤسسات الوساطة، إذ حين يدرك الفاعل المحلي، والمقاول الجهوي، والباحث عن فرصة استثمار أو تمويل، أن الاستفادة محكومة بالولاء لا بالكفاءة، فإنه لن يرى في الحكومة سوى امتدادا لحزب، ولن يرى فيها كذلك سوى لجنة تقنية تُدير لعبة مغلقة لمصلحة نخبة بعينها.
إن ما وقع في الداخلة لا يجب عزله عن مسار طويل من هيمنة اقتصادية وحزبية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي راكم منذ سنوات أدوات التأثير عبر المال والإعلام والشبكات الانتخابية. إلا أن الجديد اليوم، هو أن هذه الهيمنة بدأت تأخذ طابعاً مؤسساتياً صريحاً، يُمارس من داخل الجهاز التنفيذي نفسه، بل ويُروّج له دون حرج في الفضاء الحزبي، أمام أنظار الرأي العام.
نحن إزاء ظاهرة حزبية جديدة تتجاوز فكرة “الزبونية السياسية” المعهودة. إنها لحظة انتقال من الزبونية إلى “التسليع المؤسساتي” للدعم العمومي، حيث لا تعود المشاريع خاضعة لمنطق التنمية المجالية، بل لمنطق التموضع. والمؤسف أن ذلك يتم داخل أقاليم تعاني من هشاشة بنيوية، كجهة الداخلة وادي الذهب، حيث يُفترض أن تكون الأولوية للعدالة الترابية، لا لترتيب الامتيازات بين مكونات الحزب الواحد.
الخلاصة أن ما جرى هو إعلان صريح عن نمط تدبير حزبي للمال العام، يضرب في الصميم أخلاقيات العمل السياسي، ويطرح سؤالاً حرجاً.. هل الحزب هو من يُدير الحكومة؟ أم أن الحكومة باتت واجهة لحزب يُعيد هندسة الخريطة السياسية بما يخدم استمراره وبقائه في موقع القرار؟
إن ما جرى في الداخلة يُجسّد بوضوح السقوط المدوي لشعارات كبرى رفعها عزيز أخنوش منذ توليه رئاسة الحكومة، وعلى رأسها شعار “الدولة الاجتماعية”، الذي تهاوى أمام أول اختبار حقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص. لا يمكن الحديث عن نموذج اجتماعي جديد فيما تُدار مشاريع الدعم والتنمية وفق مفاتيح حزبية، وتُمنح الامتيازات لمن يختار الاصطفاف داخل الدائرة الضيقة للولاء. إن ما رأيناه ليس انزلاقاً، بل سلوكاً سياسياً مقصوداً يضع الانتماء فوق الكفاءة، ويُسخّر أدوات الاستثمار العمومي لترتيب التوازنات داخل التنظيم الحزبي لا لتصحيح التفاوتات بين المواطنين.
أما “مسار الثقة”، فلم يكن سوى واجهة لفظية لسياسات تُغذّي الشك، وتُعمّق الفجوة بين المجتمع والفاعل السياسي. ما تُمارسه الحكومة اليوم، بصمتها حيناً وتواطئها حيناً آخر، هو تقويض ممنهج لمعاني المشاركة، وتحويل آليات تدبير الشأن العمومي إلى أدوات تصريف حزبي ضيق، لا علاقة له بالإنصاف ولا بالمصلحة الوطنية. هذه الانحرافات، إن لم تُواجه بموقف واضح، لن تُنتج سوى المزيد من العزوف، والمزيد من الكلفة السياسية في لحظة حساسة تحتاج إلى بناء الثقة، لا إلى إعادة تدوير منطق الامتياز المغلّف بلبوس التنمية. عن برلمان كوم